– الثاني: بحث «ردّ أوهام المؤرخين والنقاد حول جنوب الجزيرة العربية – تهامة وسراة – والشعر الجاهلي»: وصل إلى حجم كتاب كامل جاوز ( 210 ص )، من ( 158 – 348 ) ، ثم نجد تهذيبًا له للكاتب نفسه/ محمد أحمد علي فتحي، بعنوان: «اليمن الجاهلية أخطاء المؤرخين وأوهام النقاد» ص ( 486 – 491 ) ، فما الداعي لذلك؟، إذ ليس مستخلصًا ( abstract ) ولا بملخص ( summary ) . وهو أقرب إلى عمل المرحوم عبد السلام محمد هارون (ت 1988م): (تهذيب كتاب الحيوان للجاحظ)، جعله في ( 300 ) صفحة بعد أن كان في سبعة مجلدات. ولا نستبعد أن يكون العمل منشورًا في كتاب مستقل، وإن كنّا نفتقد الدليل.
* حديث الشعر الجاهلي أكثره عن الأجواء الماطرة وامتلاء الأودية بالسيول وانتشار الحيوانات في الأرجاء، وأقله عن الصحراء.
* بنو أسد أول أمرهم جنوب الجزيرة.
* بكر وتغلب ابنا وائل جنوبية.
* تميم جنوبية.
* بنو عامر جنوبية.
* يزيّف قصة طَرَفة بن العبد البكري ومقتله – ومعه حق – من كل الجوانب.
* المهلهل في حِجر اليمامة لا الفرات.
* عَبيد بن الأبرص جنوبي.
* خِداش بن زهير العامري جنوبي.
* تميم بن مقبل العجلاني جنوبي.
* الحارث بن حِلّزة اليشكري جنوبي.
* سلامة بن جندَل السعدي جنوبي.
* الخلاصة أنه أكثر الكلام في (13) ثلاثة عشر شاعرًا + ( 30 ) شاعرًا كلامه عنهم مختصر نوعًا ما أو متوسط + ( 14 ) أربع عشرة شاعرة أنثى = (57 ) شاعرًا جنوبيا!!
وطبعا كان في كلام الباحث تكرار في مواطن كثيرة، بما فيها تكرار الأشعار، وإعادة لما في المقدمة، وتكرار في الخاتمة. وأحسب أنه لو لم يكبح جماح نفسه لأدخل جميع شعراء الجزيرة في السراة وتهامة.
وبعض الحجج التي اعتمد عليها يمكن أن تؤخذ عليه؛ فذكر الشاعر لمواضع لا يعني أنها من بيئته الضيقة، لاسيما ونحن نعرف تكرار أسماء المواضع في أكثر من جهة؛ خذ عندك في الجمهورية اليمنية حاليًّا وقابلها بالسعودية: الجوف، همدان، وادعة، الحوطة، سنحان، شوكان… إلخ. وأخشى ما أخشاه أن ينساق إلى التشابه فيقول – مع من قالوا – إن بون – في ألمانيا – من مهاجرين قَدِموا من قاع البَون في اليمن، وإن كوبا باسم قائد يمني من خُبان سكن الجزيرة، وكيف ننسى أن شاعر الإنجليز العظيم شِكسبير أصله: الشِيخ زِبير! ولا حول ولا قوة إلا بالله!
وأما أنهم اعتمدوا الحكايات عن الأشعار أكثر من الأشعار نفسها؛ فهو حق، لكن الذين رووا الحكايات هم أنفسهم الذين رووا الأشعار ومناسبات القول؛ فما العمل إذا لم ينطق الشعر وحده؟
ويحسب للباحث أن صياغة الأشعار – غالبًا – سليمة؛ وتبقى بعض الأخطاء واضحة منها:
– ص ( 159 )فقرة (5 ) جاءت بها آثار أولئك الجاهليون × الجاهليين.
-ص ( 161 ) فقرة (2) فهي تنسبت القبائل إلى غير ديارها وتوصف الديار بغير ما هي عليه × تنسب… وتصف.
– ص ( 170 ) فقرة (4) ما يقارب ست مئة كيلو مترًا × كيلو مترٍ. ومثله في ص ( 176) .
– ص ( 199) فقرة (1) ابن دويد × ابن دُرَيد.
-ص ( 215 ) سطر (12) تميم بن أبي مقبل × تميم بن أُبَيّ بن مقبل.
-ص (256 ) صواب الشطر الثاني من البيت ( 10) : وغروبها صفراءَ كالورسِ، كما في ص289.
-ص 287 صواب الشطر( 1) من البيت ( 5 )كأنّ الثريّا عُلّقت في مَصامّها
-ص ( 288 ) سطر ( 7 ) صوابه لَقيط بن يعمر الإيادي
-ص ( 297 )،آخر الصفحة ( 5 )أبيات أولها ليس من القصيدة، بل لا ينتمي لأي بحر!
-ص (310 ) شطر ( 2 ) من البيت ( 9 ) صوابه: مخافةَ مَن يُجيرُ ولا يُجارُ.
-ص ( 313 )في آخر سطر ينقص شطر!
-ص ( 314 ) صواب البيت ( 3) : فالرقمتين فجانب الصّمّانِ.
-ص ( 340 ) هامش ( 1)… أن يأتي باحثات أو باحثين آخرين يصوبون × … باحثون آخرون.
-ص ( 344 ) سطر (8): الزمخشري محمود بن عمرو × محمود بن عُمَر.
– ص(344 ) -المرجع ( 73 ) محمد زغلول سلام، الممتع في صنعة الشعر! قلت: م. ز. سلام ليس المؤلف، بل هو محقق الكتاب، أما المؤلف فهو عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي القيرواني التميمي (ت 403ﻫ). وللأسف فقد أورد المؤلف الدواوين وغيرها بأسماء المحققين!!
-ص (346 )مرجع (121 ) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء × … الإنشا، بغير همزة ممدودة.
وبقي عليه أن يعلّل إن كانت لغة اليمن قبل الإسلام تخالف تمامًا عربية الشمال، فبأي لغة وسيطة كان يتم بها التواصل بين قريش واليمنيين؟، لن نتحدث عن رحلة الشتاء والصيف، والتاريخ يخبرنا أن قبيلة قريش قد بعثت وفدًا لتهنئة الملك سيف بن ذي يزن بانتصاره على الأحباش، وخطب عبد المطلب بن هاشم أمامه، ومدحه أميّة بن أبي الصلت بقصيدة طويلة، ولم ينقل أن بينهم مترجمًا، وإلا فلا معنى للمدح إن كانت لغة الطرفين اثنتين مختلفتين.
الإدارة العسكرية البريطانية في الحديدة (ديسمبر 1918 – 1921م). تأليف جون بولدري، ترجمة عبد الودود قاسم مقشر، ص ( 413 – 462 ) .
الملاحظ على العنوان اختلافه عن المحتوى؛ إذ يستمر في الحديث حتى عام (1925م )عندما تسلّم (الإمام يحيى حميد الدين 1869 – 1948م) الحديدة بسلام مقابل أن يسحب قواته من الضالع ويافع العليا في الجنوب. البحث المترجَم قائم على الوثائق البريطانية، وهذا يفتح جرحًا نازفًا عند الباحثين العرب في التاريخ الحديث؛ إذ تقوم أبحاثهم غالبًا على الكتب المؤلفة والصحف، يعني ليست قائمة على من كانت القرارات المحركة للأحداث في أيديهم حقيقةً لا تنجيمًا. حتى إن حرب ( رمضان 1393ﻫ = أكتوبر1973م ) .
وقد مضى عليها خمسون عامًا – لم تسمح الحكومة المصرية بالاطلاع على وثائقها إلا منذ عام فحسب!! والله يعلم نوع الوثائق، في حين أن الطرف الصهيوني سامحٌ بذلك منذ عشر سنين بعد انتهائها.
البحث ممتاز قائم على حياد الباحث الإنجليزي فيما أحسب؛ فما نطقت به الوثائق ذكره، وعلله، وربط بين مواقف الأطراف المختلفة: الإمام يحيى، القيادة التركية في اليمن، الإدريسي في صبيا، القبائل التهامية، الإنجليز في عدن، الحكومة الإيطالية… إلخ. فبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى في ( 1918م ) رفض الإمام يحيى تسليم القادة الترك والجنود للإنجليز، بحجة أنهم مدينون له بمبالغ مالية كبيرة، وأدت المخاوف من أن حكومة إيطاليا ستستفيد من الموقف؛ فقررت بريطانيا احتلال مدينة الحديدة، وفي الوقت نفسه تمنع الإدريسي من التوسع.
في البحث تفاصيل المعارك بدقة، بما فيها هجمات أنصار الإمام يحيى المتكررة لاستردادها، والمفاوضات بين الأطراف المختلفة، إلى أن سلمتها بريطانيا للإمام يحيى.
ومن البحث علمنا أن الحديدة – تحت السيطرة العثمانية – قبل الحرب العالمية الأولى نَمَت وفيها أكثر من ( 12 ) شركة أوربية عاملة، وفيها جاليات هندية وأوربية نشطة (مع ذكر المبالغ والأصناف). وعلمنا أن من استسلموا من الترك فيهم نساء وأطفال رحلوا إلى عدن أو مصر وبعضهم اختار البقاء في اليمن. وعلمنا تعدد القادة الإنجليز وطرقهم في التفاوض والحرب.
البحث المترجم فيه أخطاء لغوية كثيرة لن أتطرق إليها، لكن سأذكر أخطاء في المعاني/ المصطلحات إن صح التعبير. ففي ص ( 421) : … لتغطية التقدم بوابل من الصواريخ!! ولم تكن الصواريخ قد اخترعت أصلًا.
وفي ص ( 422) … نفذت ( 3 ) كتائب من السرية اليمنى هجومًا…إلخ. ا. ﻫ. والبحث كله يتحدث عن كتائب هي جزء من سريّة.
قلت: في المصطلح العسكري إن الكتيبة تتكون من فصائل، والفصيلة تتكون من سرايا. ولا ينعكس.
*
نمط الأسير المُبَشِّر في الرواية المبكرة عن دخول المسيحية جنوب الجزيرة العربية قبل الإسلام، للدكتور عبد العزيز محمد رمضان. صص 139 – 157.
المقصود بِـ (الأسير المبشر): الأسير المسيحي الذي وقع في قبضة مَن هم مِن دين مختلف، فيؤثّر عليهم بسلوكه وإيمانه، فيجتذبهم إلى دينه، مع معجزات لا بدّ منها.
الدراسة نفيسة، مركّزة، لا تطويل فيها ولا تقصير، وزاد من قيمتها قيامها على مصادر ومراجع أصلية باللغات: الإنجليزية والفرنسية واليونانية واللاتينية والسريانية، وما تُرجمَ منها إلى العربية. وقال الباحث: إنه سيركز على حالتين:
1. ثيوفيلوس الهندي و2. الراهبة ثيوجنوستا. لكنه مدّ إلى حالات أخرى، منها: الأسقف بولس القنطوسي، والقس يوحنا الرهاوي.
وناقش أمورًا كثيرة، وهوامشه ثرية بالإيضاحات والاستدراكات، كما عهدنا ذلك منه في مجلدات سابقة من (القول المكتوب). وكان مما بيّنه أن وهب بن منبّه في كتابه (التيجان في ملوك حمير) تأثر بهذا النمط، الذي اختار له أسيرًا سوريًّا كان ناسكًا متجوّلًا.
وكان الغرض تاريخ معرفة هذا النمط، ودخوله الجزيرة العربية مع دخول دين النصرانية إليها، واتفقت كل الروايات على القرن الرابع الميلادي وأول الخامس تاريخا لهذا الدخول ثم الانتشار.
ولغة البحث تخلو – أو تكاد – من أخطاء الصرف والنحو.

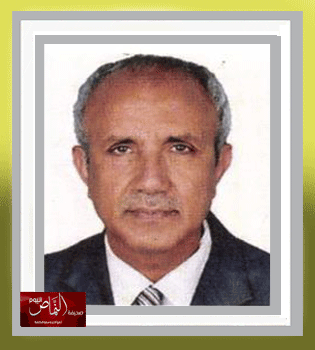


التعليقات
3 تعليقات على "ملاحظات علمية وشكلية على بعض ما في المجلد رقم (30) من كتاب ( القول المكتوب في تاريخ الجنوب) .بقلم .أ .د .عباس علي السوسوة"
ملاحظات علمية وشكلية على بعض ما في المجلد رقم (30) من كتاب ( القول المكتوب في تاريخ الجنوب) .بقلم أستاذنا العلامة. عباس
بن علي السوسوة
هذه الملاحظات ذات الجانب العلمي أكسبت المضمون قيمة علمية مضافة كونها صادرة من علامة يتمتع بمكانة علمية رفيعة وسعة اطلاع . ويمتلك منهجا علميا بأدوات بحثية رصينة بريقها مكتمل في الملاحظات الشكلية التي أعطت للوعاء الفكري المتمثل بالشكل اللغوي بيانا واضحا .
ملاحظات علمية وشكلية على بعض ما في المجلد رقم (30) من كتاب ( القول المكتوب في تاريخ الجنوب) .بقلم العلامة الاستاذ الدكتور عباس بن علي السوسوة
اضافة علمية وممنهجية اكسبت االمجلد قيمة مضافة كونها من استاذ موسوعي يمتلك منهجا علميا وبحثيا بادوات علمية فاحصة للمضمون والشكل.
يسرني أن أناقش بعض ما تكرم به د. عباس بن علي السوسوة في ما يخص بحثي (ردّ أوهام المؤرّخين والنقاد حول جنوب الجزيرة والشعر الجاهلي) وإنني أشكر له تكرّمه بقراءته، ثم التعليق عليه بما رآه.
– وله الشكر على وصفه لي بأنني أملك أدوات الاجتهاد.
– وأما قوله: (وأحسب أنه لو لم يكبح جماح نفسه لأدخل جميع شعراء الجزيرة في السراة وتهامة) فلست أدري أيستكثر على جنوب الجزيرة ذلك العدد الذي أوردته أم يرفضه ويرى خطأه؟
فإن كان يستكثره فذلك لا يقبل منه بلا دليل، وإن كان يرى أنني أدخلت في جنوب الجزيرة شعراء عاشوا في أقاليم أخرى فالأمانة العلمية تدعوه إلى بيان ذلك وتوضيحه.
– وأما قوله (وبعض الحجج التي اعتمد عليها يمكن أن تؤخذ عليه؛ فذكر الشاعر لمواضع لا يعني أنها من بيئته الضيقة، لاسيما ونحن نعرف تكرار أسماء المواضع في أكثر من جهة) فإنني قد احتطت لذلك التكرار بأن جعلت منهجي في البحث أن لا أقرر نسبة الشاعر إلى إقليم الجنوب إلا إذا تحققت شروط منها: أن يذكر بوضوح مجموعة من الأماكن الجنوبية التي لا يختلف على جنوبيتها اثنان، وأن تكون قبيلته سكنت الجنوب، وأن تكثر الأماكن الجنوبية في شعره وتتقارب.
– وأما قوله (وأخشى ما أخشاه أن ينساق إلى التشابه فيقول – مع من قالوا – إن بون – في ألمانيا – من مهاجرين قَدِموا من قاع البَون في اليمن، وإن كوبا باسم قائد يمني من خُبان سكن الجزيرة) فمثل الدكتور ينتظر منه أن يرد على ما جاء في البحث ردا علميا مؤصّلا، يثبت من خلاله خطأ ما جاء به البحث، فأما مثل ققوله هذا فلا ينتظر من مثله.
– وأما قوله: ( أدخل في اليمن – الجنوب سراة وتهامة، أكثرَ قبائلِ الوسط) فليته أورد دليلا عليه.
– وأما قول الدكتور عباس (وبقي عليه أن يعلّل إن كانت لغة اليمن قبل الإسلام تخالف تمامًا عربية الشمال، فبأي لغة وسيطة كان يتم بها التواصل بين قريش واليمنيين؟، لن نتحدث عن رحلة الشتاء والصيف، والتاريخ يخبرنا أن قبيلة قريش قد بعثت وفدًا لتهنئة الملك سيف بن ذي يزن بانتصاره على الأحباش، وخطب عبد المطلب بن هاشم أمامه، ومدحه أميّة بن أبي الصلت بقصيدة طويلة، ولم ينقل أن بينهم مترجمًا، وإلا فلا معنى للمدح إن كانت لغة الطرفين اثنتين مختلفتين.) فينتظر من الدكتور أن يفنّد الأدلة التي أوردها البحث عن اختلاف لغة (اليمن الحالية) عن العربية لا أن يلقي أسئلة تستند على روايات فيها (لم ينقل) لأن عدم النقل لا يعني عدم الوجود.
مع التأكيد على أنني حين اجتهدت لم أدّع الكمال، ولا أنزّه بحثي عن الخطأ، وإنني أعي تماما أن بحثي يخالف السائد، ولعلّ هناك من ينكره لا لخطئه بل لمخالفته لما ألفته النفوس، وإنني أتمنى من الدكتور عباس وغيره حين ينكرون شيئا مما جاء به البحث أن يطرحوا أدلة رفض علمية واضحة، وسأكون أول المرحبين بما تثبت صحته.
أكرر شكري للدكتور عباس، ولكل من يناقش ما جاء به بحثي مناقشة علمية جادة.
د. محمد بن أحمد الفتحي